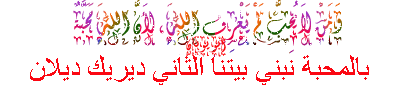الصورة للكاتب مع جدته صاحبة القصة
من يكون هذا الشاب ؟ .. أهوَّ إبنكِ .. أم حفيدكِ ؟ سألها القاضي ..!
نظرت العجوز إلى القاضي نظرةً لا تخبو من الأرتباك والتخوّف
ثم ألتفت إلى الشاب ، وصرخة صرخةً عالية أهتزّت لها جدران
المحكمة وقالت : لا...لا.. لا أسمح لكم أن تأخذوه مني .. إنه إبني
وحبيبي ، ومهما حاولتم ، لن أتركه لكم أبداً ..صاحت بصوتٍ مخنوق
وهي تبكي بمرارة وتشد الشاب إلى صدرها بقوة ، خوفاً من
إنتزاعه منها ......
من تكون تلكَ العجوز ... ومن يكون ذاكَ الشاب ... وما سبب وجودهما
بالمحكمة ... وما سر ذلكَ السؤال الذي وجّههُ القاضي إليها ..
إنها قصّة من واقع هذه الحياة ، بدأت في زمانٍ ومكان وأنتهت في آخر .
قبلَ سنوات طويلة ، عندما كانت العجوز لا تزال في ربيع عمرها
هناكَ في تلك المدينة الجميلة ( آزخ ) تزوّجت وهي في الخامسة عشر
من عمرها ، أو ربما أصغر من ذلك بقليل ..فأنجبت أول طفلٍ لها ، أحبّته
حُباً جمّاً ، كيف لا .. وهو بكرها وفرحتها الأولى في الحياة ..
كبر بولص ( وهذا كان إسمه ) وترعرع وأصبح شاباً يافعاً ، والأم
السعيدة تزداد سعادتها وفرحتها كلما رأت قامة إبنها الممشوقة أمام
أعينها تعلو يوماً بعدَ يوم ...
كانَ يوماً غائماً في ذاكَ الصباح الربيعي الباكر عندما خرج بولص مع الأغنام
نحو تلكَ المراعي البعيدة قليلاً عن آزخ .. لم يكن لوحده ، كان
إبن عمّه(توما) قد خرج أيضاً بأغنامه ، لينطلقا سويّة كعادتهم ، ثمّ
يعودان نحو المغيب . قطعوا النهر الذي كانَ يُسمّى ( سقلان ) إلى الناحية
الأخرى ، حيثُ يكون المرعى أكثرَ وفرةً ، بدأت الأغنام تتلذذ بتلك
المآكل الشهيّة ، وبولص وتوما جالسان يتحادثان وينظران إلى الأغنام
بين الفينة والأخرى ..كل شيءٍ كان يبدو على مايرام ، إلاَّ منظر السماء
الذي كان قاتماً وكأنه يوحي إلى هبوط الأمطار ، ولكن ما همَّ أولاد العم
من الأمطار .. فهي ليست المرّة الأولى التي تهطل بها الأمطار وهم خارجاً
في المراعي ..لهذا لم يعطوا للأمر أهتماماً شديداً ، وراحوا
مستمرين في أحاديثهم ..ولون السماء يزداد تقتماً وسواداً ، كان الوقت
لا يزال منتصف الظهيرة ، ولكن كان يبدو وكأنما قد بدأ الليل يُخيّم
ولم تمضي سوى لحظات حتى أبرقت وأرعدت بقوّة هائلة أرعبت الطيور
فراحت تهربُ إلى أوكارها فزعاً، وأخذ قطيع الأغنام يتجه يُمنة ويسرى
خوفاً ورعباً ، وكأنه يقوم باستعراضاً عسكرياً دون قيادة وتنسيق ،هبّت
رياح عاتية يصحبها صفيراً وأنين ، فتحت السماء أبوابها وأخذت تغمر
الأرض بشلالاتٍ من المياه الغزيرة .. نظر أولاد العم واحدهم إلى
الآخر دون كلام ، وكأنهم متفقين على نفس الرأي ، أي أن هذه المرّة
ليست كباقي المرّات ، وكأنهم لاحظوا بأنّ منسوب المياه في النهر بدأ
يرتفع شيئاً فشيئاً ، فاتفقوا دون كلام أن يعودوا بأغنامهم إلى البيت قبل
أن تحل الكارثة ، ويهيج النهر ويقطع عليهم الطريق ، فاستعجلوا بتسيير
أغنامهم وقطعوا النهر إلى الضفّة الأخرى حيثُ أصبحوا بمأمن لطريق
العودة إلى آزخ......لازالَ المطر منهمراً ، والنهر يزداد هيجاناً.....
وبرغم الضجيج والأصوات المنبعثة من قطيع الأغنام ، وتساقط الأمطار
وجريان النهر ، سمع بولص صوتاً متقطعاً قادماً من الجهة الأخرى
حيث كان هناكَ وإبن عمه قبل قليل .. ركّز أكثر على نبرة الصوت ..
فهي ليست بغريبة عنه ..إنه سمعها قبل هذه المرّة ، إنها محببة لديه .. أمدَّ
ببصره بعيداً إلى الناحية الأخرى من النهر .. أصحيحاً ماترى عيناه ..!؟
أهل هذا معقول !؟ ..لا.. إنه الخروف الذي يحبّه كثيراً ، قد ُتركَ وحيداً
في الجهة الأخرى ، فراح المسكين يصرخ ويستغيث ، وكأنه يلومهم
ويقول : كيفَ طاوعكم قلبكم أن تتركوني وأنا الصغير بينكم ، وكنتُ
مدللاً ومحبوباً عندكم !؟ صرخ بولص بأعلى صوته : لا.. لا ..لن أترككَ
ها أنا قادماً إليك ..لا تخفْ ..لا تخفْ ..وشرع في عبورالنهر .. صرخ
توما عليه مترجياً أن لا يفعلها .. ولكن كيف لبولص أن يترك
خاروفه !ألم يسمع مراراً من الكاهن في الكنيسة يقول:
( الراعي الصالح يبذل نفسه من أجل خرافه ) و( الراعي الصالح يترك القطيع كله ويفتّش
عن الخاروف الضال ) .. لا ! لا بُدَّ له من العبور مهما كانت المخاطر .
شقَّ بولص طريقه عبر النهر برغم صرخات إبن عمه وترجياته أن يعود
لكنه أستمر في مواجهة المياه الصاخبة ، حتى وصل منتصف النهر
وعينه لا تزال على الخروف المسكين الذي يحبه كثيراً .. أزدادت سرعة
المياه ، وأزدادَ غضب الطبيعة ، وما هي إلاّ لحظات ، حتى كان بولص
ينجرف ويتقلّب في المياه .. صاحَ توما ( هاوارا ... هاوارا ) أي بما
معناه النجدة .. النجدة .. دون أستطاعته فعل أيّ شيء .
لم يذهب بولص بعيداً ، فعلى بُعد عشرات الأمتار ، أصطدم بصخرة
كبيرة في وسط النهر ، فتسلقها بصعوبة ، وبحلاوة الروح عندما
ُيباغتها الخطر ، كانت الصخرة عالية عن منسوب المياه ، ربما
ذراعان أو أكثر ،جلس فوقها وهو يلهث ، وراحَ يسترجع أنفاسه
ويستجمع قواه ، ويتفحّص المشهد من حوله ، نظر هناك إلى جهة
الخاروف ، فرآه واقفاً يستغيث ، نظر إلى الجهة الأخرى فرأى
القطيع وإبن عمّه واقفاً ملوِّحاً بيديه يطلب أيضاً النجدة ويستغيث
صرخ بولص عليه بكل ما أوتي من قوّة ، وطلب منه أن يستعجل
إلى آزخ ويخبرهم ، وإلاّ سوف يهلك لا محالة .. لأن المياه كانت
ترتفع شيئاً فشيئاً ، وسرعتها تزداد أكثر فأكثر .
عندما وصل أهل آزخ ، كان بولص لا يزال جالساً على الصخرة
ومنسوب المياه قد وصل تقريباً إلى ما قبل قمّة الصخرة بقليل ..
كانت الجموع التي وصلت من آزخ كبيرة وآخرون كانوا لا يزالوا
يتقاطرون كل واحدٍ منهم بحسب إمكانيته في الجري والمسير ، ولكن
أول من وصل إلى الموقع كانوا الفرسان الذين أمتطوا صهوة خيولهم
وتسابقوا نحو المكان ..
لازال الشاب المسكين ، إبن الرابعة عشر( بولص ) جالسأ فوق الصخرة
محاولاً التمسّك والتشبّث بها ، ولا زال منسوب المياه يرتفع شيئاً فشيئاً
فوصل إلى خاصرته .. حاول أحّد الفرسان ويدعى (شمعون غزو )
عبور النهر بفرسه ( الكحيلْ ) ولكن ما إن سارَ بضعة خطوات ، حتى
تراجعَ الفرس ، وأبى العبور .. كما حاولَ البعض ومن بينهم المدعو ( عَبي )
وكانَ هذا من الذينَ يُشهد لهم بالشجاعة، ربطَ نفسه بحبلٍ طويل
محاولاً الوصل إليه ، ولكن لم يستطع الصمود أمام قوّة وسرعة المياه
الجارفة، فكانوا يجرّوه مرّة أخرى إلى حافة الشاطىء، حاولوا إلقاء الحبال
له من على بعد ، ولكن دون جدوى ، لأنّ المسافة بينهم وبينه كانت أطول
من وصول الهدف .. عملوا المستحيل ، وقاموا بمحاولاتٍ عديدة ومختلفة
ولكن كلها كانت غير ناجحة ، ولم تأتي بأي نتيجة ، وباءت بالفشل ..
مضى أكثر من ساعة على هذا الحال ، والناس لا زالت تتقاطر نحو المكان ،
وسرعة المياه تزداد وترتفع ، وبولص المسكين متشبِّث بالصخرة
تارةً ينظر ناحية المنقذين ، وتارة أخرى ناحية الخروف الذي لم يستطع
إنقاذه ..أحسَّ برجفةٍ في جسمه ، وببرودةٍ تسري بداخله ، وشعركأنَّ طاقته
بدأت تضعف ، ولكنه قاوم محاولاً التمسّك والتشبّث قدر الإمكان بالصخرة
لم تتوقف أفواج القادمين من آزخ ، لأنّ الناس كانت قد سمعت الخبر
على دفعات ، فمن كان يسمع ، كان يهبّ مباشرة للنجدة ( للهاوار )
وفجأةً وصلت الأم المسكينة ( إنها ذات العجوز التي تركناها بالمحكمة )
لكنها اليوم كانت في العشرينات من عمرها ، بكامل قواها وعنفوانها.
كان صوتها وصريخها قد سبِقاها في الوصول .. بدأت تزيح الناس
من أمامها وهي تولول وتبكي وتقول: أينَ هو أبني ؟.. ماذا حصل له ؟..
في تلكَ اللحظة كانت قد وصلت المياه إلى رقبته وكان يحاول رفع رأسه
إلى الأعلى متفادياً قدر الإمكان عبور المياه إلى فمهِ ..
كان مشهداً مأساويّاً عندما نظرت الأم فرأت إبنها هناك ..
صرخت صرخة من أعمق أعماقها ونادت عليه بكل ماأوتيت من قوّة : أبني..
حبيبي ..ولازالت تصرخ وتبكي وتنادي أبني ... حبيبي ..
لم يكن الصوت غريباً على بولص ، فمجرّد سماعه له ، أستطاع أن
يميّزه من باقي الأصوات القادمة إليه ..نعم ..نعم .. إنه الصوت الذي
أحبّه كثيراً منذ أن فتح عينيه على هذه الحياة .. لا ..ربما قبل ذلك بكثير
إنه صوت أغلى إنسانة عنده في الوجود .. إنه صوت أمّه الحنونة
في تلكَ اللحظة بالذات طنَّ في مسمعه صوتاً آخر قادماً من الجهة الأخرى
إنه صوت الخروف الذي كان يحبّه كثيراً ..وفي تلكَ اللحظة بالذات
كان قد أرتفعت المياه إلى ما فوق فمه ولا يمكنه أن يبقى جالساً ، فلابدَّ
له من الوقوف لإتمام عمليّة الشهيق والزفير والبقاء حيّاً ..ثبّتَ رجليه
على الصخرة ، وأستعان بيديه للوقوف ...ولكن الجلوس على الصخرة
ليس كالوقوف عليها .. خصوصاً في مثل تلكَ الحالة التي كان بها المسكين ..
هطول الأمطار الغزيرة ، وسرعة المياه الجارية ، ومدت
الثلاث ساعات التي قضاها فوق الصخرة حيثُ أنهكت قواه ، ناهيكَ عن
الضجيج والصراخ المنبعث من جميع الأطراف ..شعر بولص برعشةٍ
غريبة تسري في جسده .. ربما كانت رعشة الخوف من أقتراب النهاية..!
أو رعشة الوداع والحنين الأخيرة ..! نظر بسرعة خاطفة إلى جهة الخاروف ..
فبدا له باكياً حزيناً ! أدار رأسه إلى الجهة الأخرى فرآها للمرّة الأخيرة وهي
تصرخ وتلوِّح له بيداها ...كانت تلكَ المرّة الأخيرة التي
ترى بهما عينا بولص الخروف الذي كان يحبّه كثيراً .. وأمّه التي كان
يحبّها أكثر .!!
جرفته المياه الهائجة ، وغاب في لجّة الأمواج ، أمام أعين الجميع .
بعد ثلاثة أيام عُثرَ على جثة بولص في قرية ( كوفخ ) كانت مياه
النهر قد قذفته إليها .. وجِدَ عالقاً بين صخرتين ..نُقل جثمانه الندي إلى
آزخ ، فاستقبلته أمه الثكلى ، وأودعته ترابها الغالي بالدموع والحسرات.
هذه الفاجعة كانت الأولى بالنسبة لتلكَ العجوز التي تركناها في
قاعة المحكمة ، لنسرد قصّتها وسبب وجودها هناكَ ، ولربما
فقدانها بكرها وحبيبها بولص أمام عينيها ، كان أول الأسباب
برغم الفارق الزمني والمكاني البعيد جدّاً بين المشهدين :
مشهد غريق إبنها في ( آزخ ) ومشهد وقوفها بالمحكمة في (ديريك).
ولكي لا أطيل عليكم فتملونني .. سأكتفي بهذا الحد ، لأعود ثانية
وأكمل معكم إنشاءالله بقيّة الأحداث . ودمتم سالمين .
فريد توما مراد
ستوكهولم -السويد
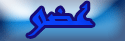



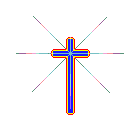

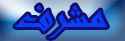
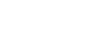 أبو بول
أبو بول