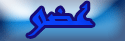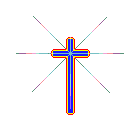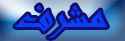ولا أُريد رؤيتها بل بالعكس كنتُ اُحبها كثيراً وكنتُ أتمنى أن تأخذني
وتضمني بين ذراعيها ،ولكنني كنت أخشى إن فعلتُ ذلك سأنالُ مؤكداً بعدها العقاب في البيت .
كان عمري وقتذاك سبعُ سنوات ، لم أكن أعلم ماذا تعني السنين وكيف يُقاس الناس بالأعمار
وما معنى الموت وما معنى الحرمان ، فطفًًًًًَلٌ
في مثل هذا السن ماذا يُريد سوى اللعب والمرح واللهو كباقي الأطفال الآخرين ،
لكن رغم كل ذلك عندما كنتُ أراها مقبلة ، كانت طلتها تبعثُ فيَّ الدفىء والإطمئنان ،
إنما عندما كانت تقتربْ منّي ، كنتُ أهرب وأختفي ، لا لأنني أكرهها ،
بلْ خوفاً من الِعقابْ ...من تكون تلكَ القادمة ؟ وماهي بالنسبة لي ؟
وماالصلة التي تربطني بها ؟ ولماذا أنا وليس غيري من أطفال الحارة ؟ .
تلكَ كانت ( أمّي ) نعم أمّي ! هي التي كنتُ أهربُ منها وأختفي كلما رأيتها قادمة نحوي .
ربما تتسألون لماذا ؟ و:كيف يهرب طفلاً صغيراً في مثل هذا السن من أمّه ؟..
وأنا بدوري سأجيبكم :
هكذا كانت العادات والتقاليد السائدة وقتذاكْ ! وهكذا كان حكمُ القبيلة والعشيرة !
( طبعاً أتكلم هنا عن بعض العادات والتقاليد وأغلبها جيدة ).
رحلَ والدي عن هذه الحياة وأنا لاأزال في السنة الأولى من عمري ، كنتُ
ِبكَرهُ ، كان في العشرينات من عمره عندما شاءت إرادة الرب له الرحيلْ
أما أمّي فلمْ تكن قد تجاوزت السابعة عشر من عمرها (كانا كلاهما في بدءِ
سنين العسل ) . لبستْ امّي ثياب الحداد وبكتْ حظها وأذرفت الدموع
وراحتْ تندبْ ماجراها ولم تجد من يستطيع أن يخفف من حزنها ويهدّأ من
رَوعِها سوى (أنا ) ! نعم فأنا إبنها الوحيد وفلذة كبدها وما تبقّى لها من
ذكرى الحبيب ورائحة الحبيب ، لهذا صرتُ بالنسبة لها شغلها الشاغلْ
وتسليتها المفضلة وضحكتها التي كانت تضحكها من خلال ضحكتي .
ومرّت الأيام والسنين ، سَبعُ سنواتٍ مرّتْ ، وأنا أنمو وأكبر في أحضانِِ
أمّي ورعاية أمّي ومحبّة أمي وحنان أمّي ، هي التي علَمتنيْ الصلاة الربّانية ،
والسلام لكِ يامريم ، وصلوات أخرى حيثُ كنّا نرددها سويّة
قبل النوم ، كانَ صوتها جميلٌ جداً وحنون وحزين تدندنْ ليَّ بهِ كلَ مساءٍ
حتّى أغفو وأنام ..
سَبعُ سنواتٍ مرّتْ ، كانت أمّي في السابعة عشر من عمرها ، أمّا اليوم
أمستْ في الرابعة والعشرين ، وبسبب أمورعائليّة( لا أريد التطرق إليها)
كان يجب على أمّي أن تتركْ البيت وتلتحق ببيت والدها ، وهذا ماحصل !
وهنا جاءَ حكم القبيلة والعشيرة ليحكم .
كانت العادات والتقاليد السائدة وقتذاكْ ( وأتكلم عن الخمسينيات من القرن المنصرم )
عندما تتركْ الزوجة الأرملة بيت حَميها لاتأخذ معها شيئاً ، حتى وإن كان
هذا الشيء أعز وأغلى ماتملك ، حتى وإن كانَ إبنها فلذة كبدها .
تركتني المسكينة مُرغمة والتحقت ببيت والدها ،في البداية لم يكن
الأمر صعبٌ للغاية لأننا كنّا لازلنا قريبين من بعض ، أي في حارة واحدة
كنت أذهب إليها وأراها وأبقى معها ساعاتٍ طويلة ، لم أكن أفتقدها أبداً إلاً
في المساء وخصوصاً عند النوم حيثُ كنتُ قد تعوّدت أن أسمع صوتها قبل
أن أغمضْ عينايَ وأستسلم للأحلام ، لهذا أستطيع أن أقول بإنّ كل شيء كان
يسير على شبهِ مايرام ، حتى جاءت اللحظة القاضية التي قلبتْ موازين حياتي
رأساً على عقب ولخبطت فيَّ الأمور بعضها ببعض فَغَدوتُ لاأفهم شيئاً وكأني
شراعاً صغيراً تتلاطمه الأمواج هُنا وهناكْ .
بدأت المأساة عندما جاءها أمّي النصيب ، وهذا حقّها ، فهيَ لازالت صغيرة وليس
من المعقول أن تبقى طوال حياتها عالة على بيت والدها.!
تزوّجت أمّي فكانَ ذلكَ اليوم يومَ حِداداً وحزناَ في بيتنا ، كان يوماً عاصفاً
غاضباً مستنكراً هذا الزواج ! وربما نستطيع القول بإنهم فعلوا ذلك من حَرقة قلبهم
على وَلدهمْ الراحلْ ، وهذا حقّهم المشروع ، لكن ماذا جرى بعد ذلكْ ؟.
بعدما كان مسموحاً ليَ أن أُقابل أمي وأبقى معها بضعةَ ساعات في اليوم
تضمني إلى صدرها وتقبلني وأقبلها ودموع الفرح في عينيها والإبتسامة
على شفتيها ،بعدما كنتُ أملىء عليها دنيتها وهيَ تمنحني الدفىء والحنانْ
والحب والطمأنينة ، بعد كلِ هذا جاء القرار الظالم وحُِكمَ عليَّ بعدمْ السماح
ليَّ مرةً أخرى الذهاب إلى أمي أو التكلم معها لا من بعيد ولا من
قريب ولا في أي حالٍ من الأحوال وسوف أنال العقاب إذا ما فعلتُ ذلك !
طبعاً القرار جاءَ من المسؤلين عني وعن تربيتي ( جدي وجدتي ) ألف
رحمة على أرواحهم الطاهرة ، وانا مديون لهما بالدعاء والترحّم ما حُييتُ
فهما رّبياني أحسنَ تربية ، كنتُ ( طفلهم المدللْ ) ، كيفَ لا ! فأنا أيضاً
بالنسبة لهم الباقي من رائحة المرحوم إبنهم الغالي ، لهذا كنت أيضاً قدْ
أصبحتُ تسليتهم الوحيدة وشغلهمْ الشاغلْ في الحياة .
ومرّت الأيام والسنين ...! سبعُ سنواتٍ وأنا أراها قادمة نحوي وأهربُ منها ،
ولازلتُ أتذكر جيداً كيف في إحدى المرات هيَ وبعضْ النسوة
حاصرنني في فناءْ ذاكَ الدارْ كي يتمكنَّ من إمساكي ، علها تستطيع ضمّي
إلى صدرها وتقبيليْ ، وكيف إنني لم أرى مخرجاً سوى ذاكَ السلم ،
فصعدتُ عليه مسرعاً نحو السطح ونزلتُ في دارٍ أُخرى كي لاتتمكنْ من
إمساكي وتقبيلي ، لا لأنني أكرهها، أبداً ، بل خوفاً من العقابْ المنتظرْ ..!
أنجبتْ أمي وصار ليّ إخوة منها ولكنني لم أرآهم أبداً ولم أعرفهم ، بل كنتُ
أسمعُ عنهم من هُنا وهُناكْ ، أذكر أيضاً في إحدى المرات وأنا واقفاً أمام باب الدار ،
وإذ بجدّيْ لأُمي يبتسم ليَّ ويقول : لقد صارَ لكَ أخّاً ،!
وُيكمل مسيره كي لايراهُ أحدّاً وهو يكلمني ويُخبر جدّي أو جدتي ، فسوف
أُعاقبْ لامحالة ، لأن القرار كانَ يشملْ كلْ الذين هُم من طرفْ أمي ،
هكذا كانت العادات والتقاليد ..
كنتُ في حوالي الرابعة عشرْ من عمري عندما طلبتُ من ْ أحّد أصدقائي
في الحارة ( كانَ هذا إبنَ عَمْ أمّي ) أن يأخذني إلى بيتها .!
كانَ ذاكَ أولْ وأصعبْ قرار أتّخذه لحين بلوغي تلكَ المرحلة من العمر
ولاأعلم لغاية هذهِ اللحظة وأنا أكتبْ ، كيف إستطاع ذاكَ الطفل بداخلي أن
يأخذ مثلَ ذلكَ القرار ، وهو يعلم حق اليقين بأنَّ العقاب منتظرهُ إذا كُشفَ الأمر !
فتحَ صديقي باب الدار ودخل وأنا من خلفه أتتبع خطواته ، كانت هُناكَ
في فناء الدار واقفة ومن حولها بعض الصبيان يلعبون ، عندما نظرتْ
إلى الباب لترى من القادم أصابها شيءٌ من الهلع حيثُ رأتني وبدأت
تبكي وتصرخ عالياً وتقول : جاءَ أخوكم .. جاءَ أخوكم ياأولاد.
مكثتُ قرابة النصف ساعة معهم وأنا أُجيبْ على الأسئلة الطفولية
البريئة التي كانَ يطرحها عليَّ إخوتي ، وأمّي تشدَّني إلى صدرها
أكثر وأكثر ، وفي بعض الأحيان كانتْ هي التي تُجيب عنّي على الأسئلة
التي كانت ترى فيها شيئاً من الحرج ليَّ وصعوبة في الرد عليها .
كانت هذه المرة الأولى التي أرى فيها إخوتي وأكلمهمْ ، بعدها تكررّت
الزيارات برغم العقوبات التي كنتُ ألقاها في كل مرة يعلم بها جدّي وجدتي
لكن دونَ جدوى ، فقد هاجَ ذاكَ الطفل الصغير بداخلي وكسرَ
القيود وراح متمرِّداً على العادات والتقاليد ، كيف حصلَ ذلكْ ؟ لاأدري
ولكن مايستحضرني الآن من تلكَ المأساة هو غياب فاعلي وصانعي
السلام وقتها ! أينَ كانوا ؟ ولماذا لم يتدخلوا ؟ وأقصد بهم رجال الدين
والمجالس المليّة ،ووجهاء الطائفة ، والحكماء ، وأصحاب الكلمة المسموعة ،
ويبقى السؤال دونَ جواب وينتهي بعلامات إستفهام
وتعجّب كثيرة ؟؟؟؟؟!!!!!
ومرَّت الأيام والسنين وقررتُ الهجرة ، كنتُ في العشرينات من عمري
في ربيع العمر واليوم أنا في خريفه فقد تجاوزت الخامسة والخمسون
ولم يبقى من العمر أكثر من ما مضى !
جئتُ إلى السويد ( وكنا من الدفعات الأولى المهاجرة ).
تزوّجتُ واستقريّتُ ورزقني المولى بطفلة أسميتها على إسمها ، وقلتُ :
آن الأوان لكي تأتي أمّي أيضاً ، علنا نستطيع أن نعوِّض مافاتنا من حرمان .
وجاءت ، وفرحتُ جداً بمجيئها ، لكن هذه الفرحة لم تدم طويلاً.
لم أكن أعلم ماذا كان يخبّىء الغيب لها ( وعلم الغيب عند الله وحده )
جاءت أمّي حاملة معها عُصارة ألم الماضي وقساوة السنين .
جاءت وهي تحمل في أحشائها وحشٌ خطير يُسمّونه ( السرطان )
هذا ما قاله ليّ الطبيب عندما سألته عن سبب ذاكَ الوجع الذي كان
ينتابُها بين الفينة والأخرى ، وأكمل قائلاً : هذا هو السرطان !
إنه أشبه بوحشٍ نائم ، فلطالما هو نائم لايشعر المريض بالألم والوجع
إنما عندما يستيقظ جائعاً يضرب بجذوره على الأعصاب ليمتص
عصارتها ، فيسبّب هذا الوجع الرهيب .! فقلتُ بيني وبين نفسي :
لا ياطبيب ! فليسَ هذا السرطان الذي يسبب الوجع والألم لأمّي !
إنما هو سرطان تلك الأيام القاسية التي عاشتها أمّي !
سرطان العادات والتقاليد ، سرطان الظلم والحرمان ، هو الذي
يضرب بجذوره على الأعصاب فيسبب هذا الوجع .!
صَبرتْ أمّي وقاومتْ سنة كاملة ، وهي تتألم وتتوجّع ، وأنا أتألم وأتوجّع
معها ، صرتُ لاأفارقها أبداً ، أجلس بجانبها ساعات وساعات نتحدث
عن الماضي وذكريات الماضي الحلوة منها والمُرّة ، وأحياناً كانت
تنظر في وجهي وتتأملني طويلاً دون أن تتكلم ، وكأنها كانت بينها
وبين نفسها تقول : لم أشبع منكَ ياإبني !هذا ماكنتُ ألمحه في عينيها.
في الأسابيع الأخيرة عندما بدأ العد التنازلي عند أمّي وأخذت حالتها
تسوء أكثر فأكثر وبدأت هي أيضاً تشعر بقدوم لحظة الوداع والرحيل
أخذ صوتها يضعف وقواها تنهار تدريجيّاً، وأنا أنظر إليها وأتألّم
وبداخلي صوتٌ ينادي ويقول: أحقاً سنفترق ياأمّي !؟
في تلك الأثناء راحت تكلمني كلاماً لم أسمعه منها من قبل وكأنه قادماً
من أعماق المحيطات وغوابر الدهور ، طلبت مني أن أُرثيها بكلمة
وأوصتني ببعض الكلام أن أقول .
( للأسف لم أستطع تحقيق أمنيتها لأسباب سآتي إلى ذكرها لاحقاً )
في اليوم الأخير لها ، وما من أحّدٍ كان يعلم بأنه الأخير سوى الله وحده !
ذهب الجميع من عندها ومكثتُ أنا بقربها ، كانت قد إنقطعت عن الكلام
نهائيّاً وكانت في شبه غيبوبة ، قال الطبيب إنها تسمعكم وتعلم ماتقولون
فالأفضل أن تتكلموا معها بإستمرار لكي تُشعروها بوجودكم معها .
كنت جالساً بجانبها ممسكاً بيدها اليسرى ، أما في يدي اليمنى كنت أمسك
كُتيّباً صغيراً يحمل عنوان أشواك الروح ، للأب كمال قلتهَ ، وأنا أقرأ لها
بصوتٍ مسموع ، وإذ بدمعة حبيسة تنحدر من عينها اليمنى وتتوقف على
خدها وتستقر ، قلتُ : أتبكينَ ياأمي ؟ وكررتُ القول مرتين ،وهنا أطلقت
أمي حسرةً خفيفة ......... ورحلت .
هكذا ودعت أمي هذه الحياة بدمعةٍ وحسرة !
آه ياأمي لوعلمتُ على ماذا كنتِ تبكين !
آه ياأمي لوعلمتُ على ماذا كنتِ تتحسرين !
قبل وداع أمي إلى مثواها الأخير أردتُ تحقيق أمنيتها ، فتكلمتُ مع
(صاحب القرار ) والمعذرة لأنني لاأُريد ذكر إسمه لأننا قطعنا عهداً
أن نلتزم بشروط الموقع ، لهذا أسميتهُ بصاحب القرار ، ترجّيته يأذن
لي أن أودّع أمي بكلمة رثاء تحقيقاً لأمنيتها . لكنه رفض !
قلت له : ياصاحب القرار ، في كل الأديان والأعراف وصيّة الميّت
مُصانة وتنفّذ ! فقال : لن أسمح لكَ .
قلتُ : هل ليَ أن أعرف السبب ؟
قال : لايحق للعلمانيين أن يتكلموا في بيت الله ! لأنه مكانناً مقدساً .
فلا يحق سوى للمكرسين ( اللآهوتيين ) بذلك.
قلتُ : ولكن نحنُ أيضاً ياصاحب القرار لسنا ببعيدين عن الأكليروس
والمكرّسين ، كُلنا أعضاء في جسد السيد المسيح الواحد ، وجميعنا
معاً يشكل هيكل الكنيسة من خلال الأسرار المقدّسة .
قالَ : أعلم ذلك ! لكنني لا أُوافق .
قلتُ : ولكنك ياصاحب القرار سبقَ ووافقتَ من قبل ، ولازلتَ توافق
لناس وناس ، وقد أذنتَ ليّ في أكثر من موقف أن أتكلم وبحضوركَ
شخصيّاً وحضور أصحاب قرار آخرين ، فما سبب هذا الإصرار
القاطع اليوم ؟ وقد شرحتُ لكَ الظروف التي عاشتها أمي ، ناهيكَ
عن إنها وأنا كما تعلم ننحدر من عائلة مسيحيّة خالصة ، لها خدمات
لا تحصى في مجال الكنيسة ، حيثُ قدّمت العديد من الشمامسة
والكهنة والخدّام ، عدا عن ذلك فكما عهدتني في كل مرة تكلمتُ فيها
لاأخرج أبداً عن نطاق تعاليم الكتاب المقدّس ، وإن أستشهدتُ أستشهد
بأقوال الرب الجليلة ، وإنني أعدكَ ياصاحب القرار أمام الله إن أذنتَ
ليّ بالكلام ، فستكون الكلمة الأخيرة التي أتكلمها بعد ذلك !
رغم كل هذه الترجّيات والتعهّدات قالَ : لا أسمحْ لكَ .
طال الحديث بيني وبينه ، ولا داعي لذكر كل التفاصيل وما قلتُ وقالْ
المهم في النهاية كان قراره قاطعاً وحازماً ( لن أسمح لكَ )
فقلتُ له في آخر النقاش : أللهمَّ إني قد بلّغتُ وبرّأتُ ذمّتي .
وُريتْ أمي الثرى وودعتها ، لكنني لم أستطع أن أحقق لها أمنيتها .
هي الآن في عالم آخر ، ونحن لازلنا في عالم الخطيئة .
بعد أسبوع فقط من رحيل أمي تُوفيَّ ( المقصي الفلاني ، مختار
القرية الفلانية ، عن عمرٍ يناهز المائة ، يملك أولاده وأحفاده
ثروة طائلة من المال ) كانت المفاجأة الكبرى عندما إنهالت عليه
إلقاء الكلمات من اللآهوتيين والعلمانيين ومن ( صاحب القرار ذاته ).
فأينَ هي العدالة الأرضية عند بعض أصحاب القرار ؟!
وأينَ لهم من العدالة السماوية يوم الحِساب والدينونة ؟!
لو علِمتَ ياصاحب القرار ماذا كانت قد أوصتني أمي لأَقوله !
لعشتَ ماتبقى لك من عمر في ندمٍ عظيم ؟!
لكنني لستُ مضطرّاً أن أُعلمكَ بعد الآن ، يكفيني الله هو العالِمْ !!.
أمَّا ماأتخذتهُ من قرار يا (صاحب القرار ) في حقّي وحقَّ أمي
إسمح لي أن أقول : كان قراراً ظالماً ، ولم أرى فيه سوى إمتداداً
لبعض تلكَ العادات والتقاليد القبليّة والعشائريّة التي قاسينا منها أنا وأمي !.
فريد توما مراد
ستوكهولم - السويد
2012-10-17