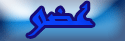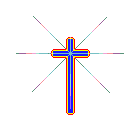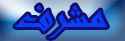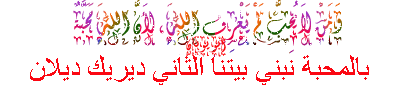تتمة قصة مأساة أم . الجزء الثاني
الصورة للكاتب مع جدته صاحبة القصة
كان ( بولص ) بِِكرًا لأمّه ، ولكن لم يكن وحيدها ، فعندما رحل كان
قد تركَ خلفهُ أبّاً حزيناً ، وأمّاً ثكلى ، وثلاثة إخوة صغار السن
تتراوح أعمارهم مابين السنة والعشر سنوات ، جميعهم صبيان
فطوال مسيرة إنجابها من البداية وحتى النهاية كان قد رزقها الله
بأحّدعشر صبيّاً ، وطفلة واحدة فقط ، إنما الذي أعطاها لم يترك
لها في النهاية سوى الطفلة وأثنان من الصبيان فقط ..! فبعد مصيبة
بولص ، وكأنَّ باب المصائب فتح عليها ، فلم يمهلها الألم سنة واحدة
بحيث أنها لاتكاد تنتهي من لملمة جروحاتها ومحاولة التخفيف
من حمل أحزانها بفقدانها أحّد أولادها ، حتى يباغتها الموت ثانية
وينقض عليها كالنسر الجارح عندما يهبط من فوق وينقض على فريسته
ليخطف من بين أحضانها ولداً آخراً...... وهكذا ودّعت الأم التعيسة
تسعة ذكور مابين رضيعاً وطفلاً وشاباً ، كان أولهم ( بولص في آزخ )
وآخرهم ( بولص في ديريك ) لأن المسكينة كلما كانت تخسر ولداً
ثم يرزقها الله بولدٍ آخر كانت تسمّيه على إسمه ، وكأنها به تخلِّد ذكر
أخاه الراحل ..!
أجل تسعة زكور رأوا نور هذه الحياة لمدة من الزمن ، ثم غادروها
عن أعمارٍ مختلفة ، وأسبابٍ متعددة ، لهذا قد يطول الكلام لو تطرَّقتُ
إلى ذكر كل واحدة منها على حِدا ، ولكن سأكتفي بذكر البعض فقط ...
لم يمضي الكثير على رحيل بولص ، ولم تكن الأم المسكينة قد أستفاقت
من هول الصدمة ، فنفسها لازالت منكسرة ، وصدرها لازال يطلق الحسرة
تلوى الحسرة ، والآخ تلوى الآخ ، ولكن ماذا تفعل وليس في
اليدِ حيلة ، وإبنها لن يعود ثانية ، وها هو الله قد أمنَّ عليها بثلاثة أولاد
بالتأكيد سيملؤن عليها دنيتها ، وُيبهجون أيامها القادمة ، ويزيلون آثار
الحزن والهم والغم من على صدرها ، لهذا تنفستْ الصعداء وشكرت
الله وقالت: لتكن مشيئتكَ يارب ..
لم تكن الشمس قد ودّعت سهول ( آزخ ) بشكلٍ تام ، فلازالت بعض
خيوطها الذهبية تنعكس على تلكَ الأسطح الترابيّة ، حيثُ بدأت الأمهات
تجهيز أفرشة النوم فوقها ، استعداداً لأستقبال الليل القادم ، وظهور
القمر ، وللأللأة النجوم ، عندها تبدأ السهرات الحلوة التي كانت تنقضي
على حكايات القصص ، والنكات الطيّبة ، والأغاني الشعبية ، والصلوات
هكذا كانت ليالي الصيف عندهم في ذاكَ الزمان ، وعندما كانَ يسرقهم
النوم ، ينامون وهم مرتاحيّ الفكر والبال ، قانعينَ بما رزقهم الله .
نظرت الأم إلى طفلها قبل أن تستودعه فراشه ، فبدا وكأنه ليس على
مايرام ، قرَّبت منه مصباح الكاز لتنظر في سلامته ، فبدا لها وكأنّ
بعض النقاط الحمراء قد ظهرت على وجهه ، ولكي تتأكد أكثر من الأمر
كشفت على بطنه وظهره وباقي أطراف جسمه ، فقالت بينها وبين نفسها:
إنها (الحصبة ) فهي لا مهرباً منها ، آجلاً أم عاجلاً كانَ سوف يلقاها
ولطالما أُصيبَ بها ، وأخاهُ الأكبر منه لازال ينتظرها ، فمن الأفضل أن
ينام بجانبهُ حتى ينعدي منه ، ويكون بهذا قد أرتاحوا كلاهما منها في آنٍ
واحد .
لم يكن فارق السن كبيراً بين (كبرو ) الأخ الصغير ، وبين ( عيسى )
أخاهُ الأكبر منه ، سوى سنة واحدة وبضعة أشهر ، فكان الأول في الثالثة
من عمره ، والثاني يقترب نحو الخامسة ، أمَّا أخاهم ( إسحق ) إبنَ العاشرة
من عمره ، كان قد عبرَ حاجز( الحصبة ) وأنتصر عليها بعد المقاومة الشديدة ،
( في تلك الأيام لم يكن العلاج ضدَّ أمثال هذه الأمراض
قد ظهر ، ولم يكن لقاح للأطفال كما هو اليوم ، حتى الأدوية كانت بدائيّة وبسيطة جدّاً
والعلاج أولاً وآخراً كانَ بالإتكال على الله ، ولكن لغاية يومنا هذا نرى وللأسف – الحصبة –
تكسح العديد من الأطفال خصوصاً في البلاد الفقيرة التي ينقصها اللقاح والعلاج الكافي ).
بعد مرور بضعة أيام ، كانت النقاط الحمراء قد أنتشرت في جسم عيسى
كله ، فلاحظت الأم التي كانت تراقبه دوماً ، ففرحت وأستبشرت خيراً
ودعتْ إلى الله أن يُعجِّل بشفائهما ، وراحت تسهر عليهم الليل بطوله
ولا تعرف من النوم إلاَّ القليل ، كل ذلك من أجل خدمتهم وراحتهم وتخفيف الوجع عنهم ...
أرتفعت حرارة الصغير فجأةً ، فقلقت الأم المسكينة عليه كثيراً ، وأخذت
تبلل بالمياه الباردة قطعٌ من القماش وتضعها على جبينه ، وهي تدندن
له بالصلوات والإبتهالات والتضرعات ، علّه يكف عن ذاكَ الأنين الطفولي المتقطّع الذي
كان ينتابه بين لحظةٍ وأخرى ، ويستفيق من شبه الغيبوبة التي كانت تأخذه أحياناً ، وتعود به أحياناً أخرى ..أخذت
يده الناعمة بين يديها وقرّبتها من فمها وقبَّلتها بحنان وهي تقول :
ليتني أنا ولا أنتَ ياحبيبي ... آهٍ لو علمتَ يابُني كم أنا معذّبة
وتعيسة الآن بسببكْ ..! آهٍ لو أستطعتُ أن أقطع من عمري وأضيفه
على عمركَ ، لفعلتُ يا بُني ..! لو أستطعتُ أن أفديكَ بروحي لما
تأخّرتُ يابُني ، قولي مابكَ ؟! ومن أيّ شيءٍ تشكو ؟! وعلامَ هذا
الأنين ؟! أتمنا أن تنطق وتقول ليّ ولو كلمة واحدة تشفي بها لوعتي
وغليلي ، ولكن أين لكَ من هذا وأنت لاتزال بعمرِ البرعم المندّى ..
أستمرّت الأم في مخاطبة إبنها طوال الليل ، كانت في نفس الوقت
تراقب إبنها الآخر (عيسى ) وتجس بيديها حرارته ، وتقبّل جبينه
تارةً ، وخدّه تارة أخرى ، عندما كانت تراهُ نائماً ، لا يئنّ ويشكو
كأخاهُ ، برغم حرارته التي كانت تبدو مرتفعة أيضاً ولكن بنسبةٍ
أقل ، وكان وضعه يبدو طبيعيّاً ، لهذا كان تركيزها على الصغير
أكثر ، الذي بدى وكأنَّ أنينه ينخفض، وقوّته تضعف أكثر فأكثر.
مع بزوغ الفجر فتح الصغير عيناه الذابلتين ، ونظر إلى أمّه
نظرةً غير منقطعة ، فاستبشرتْ الأم خيراً وقالت : الحمدلله لقد
فتح عينيه مرّة أخرى ..لم تكن تعلم المسكينة بأنها المرّة الأخيرة..!
شهق الطفل شهقة عميقة ناعمة ، وأسبل عينيه البريئتين ، وودّع
أمّه ، وهذه الحياة ...
في الصباح دقَّ ناقوس كنيسة العذراء معلناً أنتقال ملاك أرضي
صغير، وأنضمامه إلى ملائكة السماء .. نُقلَ الملاك إلى الكنيسة
ليوّدع من هناك إلى مثواهُ الأخير .. طلبت الأم من إبنها إسحق
أن يعتني بأخاه المريض (عيسى ) ريثما تتم مراسيم الصلاة
والدفن ، فأجابها والدموع مغرورقة في عينيه : لاتخافي ياماما
فسوف أجلس بجانبه وأعتني به جيّداً .. قبّلت الأم إسحق ، ثم
طبعة قبلة أخرى على جبين إبنها عيسى ، وهي تنهج بالبكاء
على إبنها الراحل كبرو ،فابتسم لها إبتسامة رقيقة ، وفتح فمه وكأنه أرادَ أن يتكلم ويقول
لها شيئاً، لكنَّ الكلمة الوحيدة التي نطقها ، كانت كلمة ماما.. قبَّلته أمّه مرّة أخرى وقالت :
سأعود إليكَ قريباً يابُني .. ثمّ تركته مع أخيه وسارت حزينة ، مكسورة القلب والخاطر.
كانت الشمس قد أخترقت منتصف النهار ، عندما تمَّ الإنتهاء من
مراسيم الدفن ، والعودة إلى البيت . لم تكن الأم لوحدها عندما
دخلت الحوش ليركض أمامها إبنها إسحق ويستقبلها ، فتفتح
له ذراعيها وتضمّه إلى صدرها بشدة ، وكأنها به تخفف من
حزنها ... كانَ تقريباً كل الذين شاركوا في مراسيم الدفن ، ومعهم
كاهن الرعيّة قد دخلوا الحوش مع الأم ، لإتمام واجبات أخذ الخاطر
ومواساة أهل الفقيد ( هكذا كانت العادة .. ).
سألت الأم إبنها إسحق عن وضع أخاهُ عيسى فقال : لقد طلب
ماءً فسقيته ، بعدها بقليل أخذته الغفوة ونام ، وكنتُ بين الحين
والحين ، أسترق النظر إليه ، فأراهُ لازالَ نائماً ياأمّاه ..
دخلت الأم لتطمئن عليه ... ولكن ..... ماذا حصل؟....؟؟؟!
ما هذه الصرخة الملتهبة ..؟! وما هذه الآه المختنقة ..؟! وما
هذه ال... لا ...يارب .. العميقة .. المنبعثة من تلكَ الغرفة ..؟!
سألَ الموجودون في بهاء الحوش ، بعضهم بعض ، وعلامات
التعجّب بادية في عيونهم .. ياترى ماذا حصل ؟.
نعم .. لقد حصلَ ما لايخطر على بال ، حصلَ أمراً مروِّعاً لايُصدّق
فعندما دخلت الأم الحزينة لتكشف على إبنها النائم ، رأتهُ فعلاً نائماً ..!
ولكن كانت نومتهُ الأبديّة ، لقد خسرت إبنها الثاني أيضاً في يومٍ واحد ..!
رفعت الأم يداها نحو السماء وصرخت بحرقة وقالت : رحماكَ يارب ..
ألطف بيَّ يارب .. آهٍ لو علمتُ ماذا فعلتُ ، وأي ذنبٍ أرتكبتُ ، لكي
أتعذب هكذا ..؟! لقد قتلَ أبي وإخوتي الثلاثة أمام أعيني ، رمياً بالرصاص ،
ومات إبني غريقاً وأنا أنظر إليه ، واليوم دفنتُ إبني
الصغير بيدي ، وها أنا ذاهبة لأدفن أخاهُ الأكبر .. أرحمني يارب
فأنا لا زلتُ صغيرة وبحاجة إلى رحمتك .
عندما صدر فرمان بقتل المسيحيين ، أيام الحرب الكونيّة الأولى
هربت هذه الأم وهي طفلة مع أمِّها من قرية ( عميرين ) وألتجأت
بآزخ ، بعد قتل والدها وإخوتها كما أسلفنا أمام أعينها ،وهنا أسمحوا لي أن
أعود بكم قليلاً إلى الوراء ، إلى الجزء الأول من القصة ، حيث كان بولص
متشبثاً بتلك الضخرة منتظراً النجاة ، والمحاولة الأولى التي قام بها ذاك الفارس ،
ممتطياً ظهر جواده ( الكحيل ) كان يدعى شمعون غزو ..
وشمعون غزو هذا كان وقتذاك مختاراً لآزخ .. فعندما هربت الأم المسكينة مع أمها
من قرية عميرين وألتجأن بآزخ ، تزوجت أمها من هذا الرجل ، بينما هي كانت لاتزال
في التاسعة من عمرها ، لهذا كان شمعون غزو يُعد بمثابة والدها ، حيث ترعرعت في بيته ،
لغاية زواجها من المدعو مراد كبرو توما الذي تقاسم معها المآسي ....
وكانت أمها قد أنجبت لها منه أختان هما ( صاري وغزالي ) رحمهم الله..
وصاري هذه تكون والدة الفنان التشكيلي كابي ساره ..... فمن عميرين مسقط رأسها
ومن تلكَ القرية المنكوبة ، التي أبيدت ذكورها ولم ينجو منهم إلاَّ القليل
أجل من هناك بدأت مأساة هذه الأم وهي لا تزال طفلة صغيرة ، لتنتهي
هذه الماساة عند تلكَ العجوز التي تركناها هناك في( الجزء الأوّل) في ديريك ، تصرخ في قاعة المحكمة وتقول :
إنه إبني .. إنه إبني ... ولا أسمح لكم أن تأخذوه مني .....
وإلى الجزء الثالث والأخير أترككم بحول الله
ودمتم سالمين .
فريد توما مراد
ستوكهولم - السويد