كانت الأسرة مكوّنة من خمسة أفراد عندما هاجرت آزخ
وأستقرّت في ديريك ( الأم والأب وطفلة وإثنان من الأولاد )
هذا بعد أن كانت الأم المسكينة قد وارتْ ثرى آزخ سبعة من
فلذاتِ كبدها ، نعم سبعة ذكور دفنت في ذاكَ التراب الغالي
ورحلتْ وهي تزرف دموع الأسى والحزن عليهم ، وتندب
حظها التعيس في هذه الحياة ، وكم قاست من آلام وويلات...
تسارعت الأحداث أمام عينيها ، فها هم والدها وإخوتها الثلاثة
يُعدَمون أمام ناظرها .. وها هو إبنها البكر بولص تجرفه المياه
بعيداً عنها .. وها هي تخسر ولديها كبرو وعيسى في يومٍ واحد ..
وها هو أخاهم إسحق أيضاً يتبعهم بعد سنة واحدة من رحيلهم ..
وها هم الذين أنجبتهم لاحقاً ( شكري و كبرو وتوما ) قد فارقوا
هذه الحياة أيضاً بأسبابٍ مختلفة .. أنحدرت من عينها دمعة ساخنة
فأطلقت حسرةً عميقة ونظرت نظرةً حزينة إلى آزخ وقالت :
آهٍ منكِ كم كنتِ قاسية عليَّ .. ولكن برغم قساوتك إنني أحبكِ
أيّتها الغالية على قلبي .. وكيفَ لا أحبكِ وقد تركتُ أولادي السبعة
أمانة عندكِ .. لقد أستودعتكِ أجمل زهرات بستاني .. أمانة يا عزرت آزخ
أحرسيهم .. امانة يا آزخ بينَ حنايا ترابكِ الغالي أحفظيهم ...
لقد أصبحوا بعد اليوم يتامى ، لا أمّ لهم ولا أب ، فكوني أنتِ يا حبيبة
أمّهم وأباهم .. وها نحنُ نودّعكِ ، ولا نعلم سنعود إليكِ ثانيةً ، أم
أنه الوداع الأخير ......!!!
كانَ يوماً متعباً وشاقاً من أيام صيف عام 1943 م ، عندما تركت
العائلة آزخ سيراً على الأقدام لتعبر تلكَ السهول والهضاب ، وتجتاز المياه
وتقاوم قيظ الصيف الشديد ، متّجهةً نحو ديريك ، كانت الوسيلة الوحيدة
التي تريحهم قليلاً من عناء السير ، ذاكَ (الحمار) الذي كانَ الجميع يتناوب
على ركوبه ، ماعدا الأب الذي قطع المسافة كلها سيراً على الأقدام .
أستقبلتهم ديريك وفتحت لهم صدرها ، كيفَ لا .. وديريك التي بدأت
تأخذ مكانة آزخ تدريجيّاً ، فأهل آزخ بدأوا يهاجرون إليها ويقطنونها
قبل حوالي العشرين عاماً أو أكثر من قدوم العائلة إليها ، فهم
جميعهم أهل وأحباب ، لا بل عائلة واحدة ، لهذا لم يلقوا أيُّ
صعوباتٍ عند وصولهم إليها ، من حيث المسكن والمأكل
والمشرب ..وهكذا بدأت العائلة حياتها الجديدة في موطنٍ جديد ..
عندما أنطلقت العائلة في مسيرة الحياة الجديدة ، كان ( شكري )
في حوالي السنتين من عمره ، وهوغير شكري الأول الذي دفنته
الأم في آزخ ، وكما أسلفنا سابقاً كانت هذه الأم التعيسة كلما فقدت
ولداً وأنجبت غيره أسمته على إسمه ، أما شكري هذا وهو حالياً
( القس شكري توما مراد كاهن كنيسة مارجرجس للسريان الأرثوذوكس
بحلب ) وكانَ يليه ( بولص ) تصاعديّاً ، حيثُ كان يبلغ السادسة
وقتذاك ( وهو والد كاتب هذه الأسطر ) وبأسم بولص الأول الذي غرقَ
في مياه الفيضان .. أما الطفلة ( سوسيه ) وهو تدليل لأسم ( سوسان )
كانت في حوالي التاسعة من عمرها... بعدها ببضعة سنين أنجبت الأم
طفلين آخرين ( عيسى وإسحق ) بفارق السنة ونصف السنة فيما بينهم
وأسمتهم أيضاً بأسماء أخوتهم الذينَ توفاهم الله في آزخ...أمَّا إسحق
الصغير والأخير في العائلة لم يمكث معهم سوى سنةٍ واحدة ليلتحق
بعدها بأخوته الملائكة ( السبعة ) الذين سبقوه إلى جنّات النعيم ..
كبرت الطفلة سوسان وأصبحت شابّة وتزوجت وأنتقلت إلى دار زوجها ..
وكان بولص في حوالي التاسعة عشر من عمره عندما كُتب له
النصيب أيضاً ليلتقي بشريكة حياته ( سوزان ) فيتحابان ويتزوجان
كانت الفرحة الأولى بالنسبة للأم الحزينة ، فها هو أول عريس
من أصل إحدى عشر شاباً تتكحّل عيناها الذابلتين برؤيته وهو في
ثياب العرس ، تقف بجانبه عروسته الجميلة التي أحبّها حبّاً جمّاً
وهي متشحة بثوب الفرح الأبيض ، والفرحة على وجوههم ،والسعادة
تغمر قلوبهم ، وربما في تلكَ اللحظة نست الأم كل أحزانها وألآمها
كيفَ لا .. وها هو بولص يتزوج ، وكأنما بزواجه يُحيّ ذكرَ أخاه
(بولص الأول ) لا بل ذكرى كل أخوته الذين رحلوا إلى تلك الديار الأبدية
وهم في مبتدأ العمر ، فشكرت الله وبكت ، ولكن هذه المرة بدلَ أن تكون
دموع الحزن والنحيب ، فدموع الفرحة والغبطة هي التي أنحدرت
من عينيها كشلال نهرٍ متدفق ......
بعد حوالي السنة وبضعةِ أشهر من زواج ( بولص وسوزان )
رزقهم المولى بطفلٍ أزادهم فرحة وسعادة ( وهو كاتب القصّة )
فأطلق عليه والده أسم ( فريد ) تيمناً ومحبّة بالمطرب المحبوب
فريد الأطرش ، الذي كان قد ذاع سيطه تلكَ الأيام ، فكانت أغانيه
محببة جدّاً عنده ....
أصبح الطفل الصغير ألعوبة كافة العائلة ، وشغلهم وتسليتهم في
الحياة ، لهذا مضت عليهم أيام سعادة ربما لم يتذوّقوها من قبل
وخصوصاً ( جدّة الطفل ، الأم التعيسة ) ، ولكن لم تمضي على
هذه السعادة والفرحة سوى سنة واحدة وبضعة أشهر ، حتى أنقلبت
موازين العائلة مرّة أخرى رأساً على عقب ، وخيّم عليها ظلام
الحزن والأسى من جديد ..
أُصيبَ بولص بمرض ( الأبوصفار ) الذي أودى بحياته خلال
أسابيع معدودات ، ليرحل من هذه الحياة ، تاركاً أعمق حسرة
في قلب والدته المنكوبة ، وأكبر صدمة في صميم أرملته التي
كانت لا تزال في ربيع عمرها ، أما الطفل فكانَ لا يدري ولا
يفقه لشيء ، لأنه كان لا يزال في السنة الأولى ونصف
السنة من عمره ....
حطّت حرب عام 1973 م بين سوريا وإسرائيل أوزارها
وقتلَ من قتلْ ، وبدأ الجنود يعودون إلى منازلهم وأهاليهم
فبقيت عين الأم ترقب عودت إبنها ( عيسى ) الذي تأخر عن
بقيّة الجنود العائدين من الحرب ... طالَ الإنتظار وعيسى لم يعود
وتضاربت الأنباء بشأن عودته ، والأم المسكينة كل يوم
ترفع يداها إلى فوق تصلّي وتتضرّع إلى الله أن يعود إبنها
إليها بسلامة ، لأنها لا تقوى ولا تتحمل أكثر من ذلك ..
ومرّت الأيام وبقى عيسى مجّرد أحاديث وأقاويل وتوقعات
لا أحّداً يعرف له مصيراً ، حتى جاء اليوم الذي أهتزّت له
ديريك ، ففي تلكَ اللحظة كان الكثير من الناس يتتبعون الأخبار
عبر المذياع وإذا بصوت عيسى يقول
توما من محافظة الحسكة ، مدينة المالكية ، أُهدي سلامي إلى أمي
وأبي ، وإلى زوجتي ( شاميرام ) وإلى أخي شكري ، وأخي فريد
أطمئنوا أنا بخير ... ) كانَ عيسى أسيراً في إسرائيل ..........
وخلال دقائق كانَ ذاكَ الشارع يعجُّ بالناس ، كلهم أتوا ليزفوا البشرى
خصوصاً للأم المنكوبة ، ولكن في تلكَ الأثناء كانت الأم
لاتدرك سبباً لتلكَ الفرحة من حولها ، لأنها كانت قد فقدت
عقلها عندما طال إنتظارها على إبنها ، وفقدت الأمل برجوعه
فكانت لاتعني لها كثيراً كلمة ( أسير ) ......
بقي عيسى مدة ثمانية أشهر في سجون العدو ،كانَ عريساً
جديداً عندما وقع أسيراً ، وكان الله قد رزقه بطفلٍ
وهو في الأسر ، فأعلموه بذلك عن طريق
الصليب الأحمر ، فأرسل إليهم وطلب أن يسمونه ( براء )
وقال: أطلبوا أن أنال على وجهه البراءة ...
في تلكَ الأثناء حيثُ كانَ لايزال عيسى في الأسر والأم
فاقدة عقلها ،كان حفيدها ( فريد ) قد أستلم دفتر خدمة
العلم ( مع العلم أن الوحيد بحسب القانون السوري يُعفى من
الخدمة الإلزاميّة ) لكن كان الطفل فريد عندما توفي والده
سجله جدّه على قيد نفوسه ، لأن الأب قبلَ وفاته لم يكن قد
عقدَ زواجه في الدولة (دائرة النفوس ) أي بمعنى كانَ لا يزال
غير متأهل في نظر الدولة ، لهذا السبب أكتتبه جدّه على أسمه
فصارَ تلقائيّاً يُعدْ أخَّاً لشكري وعيسى ، وليس هناكَ مفرّاً من
خدمة العلم ، لهذا كانَ من المفروض رفع دعوى جديدة إلى
المحكمة ، مع الأدلّة والبراهين والشهود التي تثبت صحة
الأقوال ، وتنقذ الشاب من الخدمة الإلزاميّة ، لكونهُ وحيداً
لأباه ، ولتكميل النسل ......................
وهنا أيها الأحبة ونحن نقترب من نهاية القصة ، دعوني
أعود بكم إلى بدايتها ، وإلى تلكَ العجوز في المحكمة
عندما سألها القاضي : من يكون هذا الشاب ؟ .. أهوَ
إبنكِ ، أم حفيدكِ ؟..
قبلَ الدخول إلى قاعة المحكمة قال لها المحامي (يوسف أبراهيم ) :
إذا سألكِ القاضي عن فريد ، فقولي إنهُ حفيدكِ ، وليسَ إبنكِ
لكي لايأخذوه إلى العسكرية .. فكانت تجيبه بنعم في كلِ مرة
يطرح عليها هذا السؤال قبل المثول أمام القاضي ...
كانَ الشهود من وجهاء الطائفة الموثوق بهم ( الشمّاس المرحوم
يوسف القس كبرو ، والمرحوم بولص حنا القس )
اللذان كانا يتكلمان كلاماً موزوناً ، فصيحاً ، لا يقل أبداً عن
خرِّيج يحمل شهادة بالأدب العربي ...
بعد أن أستمع القاضي إلى مرافعة المحامي وأقوال الشهود
وأعتراف الجد (مراد) بالحقيقة ، جاء دور الجدّة ( حانا )الأم التعيسة
ليوجّه إليها القاضي السؤال الحازم الذي هزَّ كيانها وأرعبها
وهي التي قاست ما لم تقاسيه أم ، وذاقت المرّ مراراً عديدة
كيف يتجرّأ هذا الذي أمامها ويقول لها أتعترفينَ بانّ هذا الشاب ليس
إبنكِ ...!!... وهنا دوتْ تلكَ الصرخة ، لتزعزع أركان المكان
وتقول : لا... لا ...لا لن أسمح لكم أن تأخذوه منّي ..!!!
إنه إبني .....إنه إبني ... وشدّته بقوّة إلى صدرها .
تمنيتُ في تلكَ اللحظة ( لأنني الشاب الذي شدّته إلى
صدرها وهي تبكي بكاء طفلٍ فقد أمّه وليس بكاء أمٍّ فقدت
طفلها ، لأنّ تلكَ الدموع لم أرى لها مثيلاً في حياتي كلها
إلاَّ في عيون الأطفال الحزانى ) تمنيتُ وقتها لو خِسرتُ القضية
من أساسها ، وذهبتُ إلى خدمة العلم ، فقط بقيتُ في تلكَ
اللحظة بنظرها إبنها وحبيبها ، لأنني لغاية هذه الساعة وأنا أكتب
فيها هذه المأساة ، لا زلتُ أحس برعشة صدرها تسري في
جسدي ، وبتلكَ الدموع الساخنة تبللُ عنقي ..
لم تدم المسكينة طويلاً بعد رجوع إبنها عيسى من الأسر ( وهذه
كانت أمنيتها ) ودّعت هذه الحياة كطفلة صغيرة( بأبتسامة حزينة )
..وآهٍ طويلة مغزاها عميق ......
( تمت بعون الله ) .... أشكر متابعتكم .
فريد توما مراد
ستوكهولم - السويد
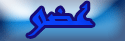

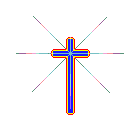





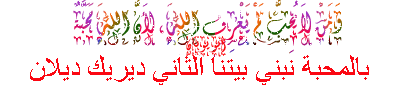
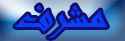
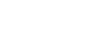 أبو بول
أبو بول